-
علمناكم الحياة وتذبحوننا بالماء.. "غزة"
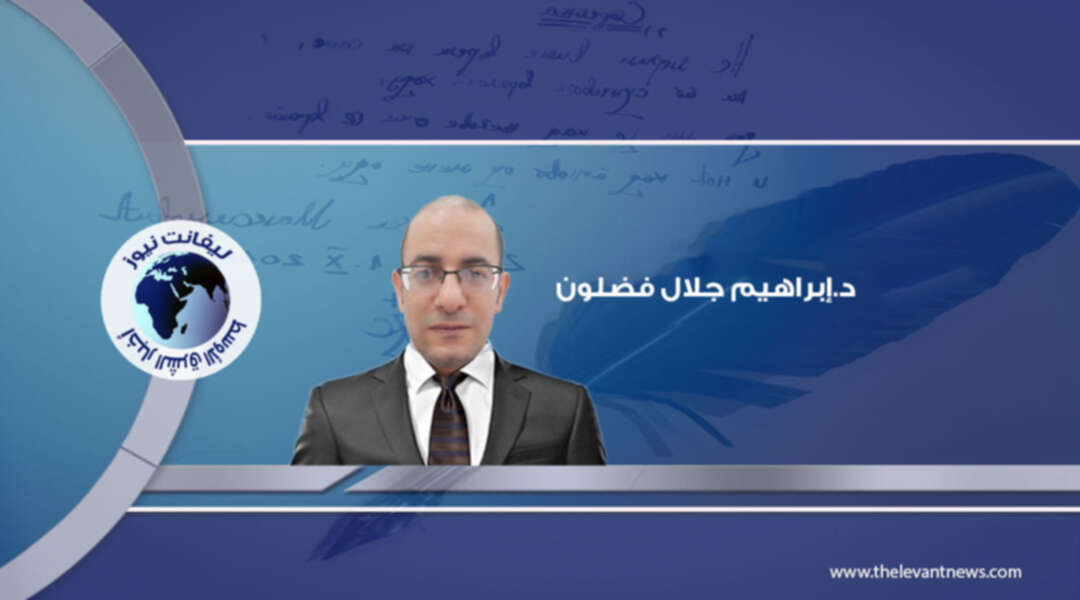
يقول المؤرخ الفرنسي دريبار: "نحن الأوروبيين مدينون للعرب (يقصد المسلمين) بالحصول على أسباب الرفاه في حياتنا العامة فالمسلمون علمونا كيف نحافظ على نظافة أجسادنا، فإنهم كانوا عكس الأوروبيين الذين لا يغيرون ثيابهم إلا بعد أن تتسخ وتفوح منها روائح كريهة. فقد بدأنا نقلدهم في خلع ثيابنا وغسلها. وكان المسلمون يلبسون الملابس النظيفة الزاهية حتى إن بعضهم كان يزينها بالأحجار الكريمة كالزمرد والياقوت والمرجان".
فالشعوب تتعلم من بعضها، والتقاليد والعادات خاصية لكل شعب، يجب أن نحترمها حتى وإن لم نتفق معها، لكن ما فعله الأوربيون هو أنهم ناكرون للجميل، كاليهود لا عهد لهم ولا أمان بينهم، فقد أخذوا منّا أجمل ما فينا وأورثونا أسوأ ما فيهم، فالتاريخ لوساخة أوربا معروف وفى الكتابات لا الأساطير، والحقائق لا الخيالات، كما جاء في كتاب (اعترافات برجوازي) للكاتب ساندور ماراي، مؤرخاً لتاريخ الوساخة في أوروبا التي كانت تعتبر المياه العدو الأول لها، معترفاً بأن الاغتسال الكثير يضر بالصحة، فقد كان الأوربيون كريهي الرائحة، بل ويعتبرون (الاستحمام كُفرًا)، ووصف مبعوث روسيا القيصرية ملك فرنسا (لويس 14) المعروف بـ "ملك الشمس" وسار بذكره الركبان، بقوله: "إن رائحته أقذر من رائحة الحيوان البري".. بل وكان قذرًا ولم يستحم إلا بناء على وصفة طبية، وهُناك مثل إنجليزي يقول: "لو كانت أوروبا منزلاً لكانت بريطانيا هي البهو وإيطاليا هي المطبخ وفرنسا هي المرحاض"، حيثُ كان الفرنسيون من القرن الـ 15 وحتى القرن الــ20 وطيلة حوالي 5 قرون ينبذون الاستحمام ويتعايشون مع أوساخ أجسادهم، ولهذا المثل حقائق تاريخية تؤكد بأن فرنسا كانت وما زالت مرحاض أوروبا، لأن كل القاذورات كانت موجودة فيها، حتى تم إنشاء "قانون بوبيل Poubelle" عام 1883، لاستخدام حاويات النفايات، والغريب أن فرنسا كرمته بأن أطلقت اسمه على الزبالة -أكرمكم الله- تم تحول لاسم (Laboball) باللغة الفرنسية
إن اعترافات هذا البورجوازي لم تقتصر فقط على ما عاشه وسط عائلته الغنية، بل أيضا امتدت لتشمل تاريخا طويلا من العفن الأوروبي، والذي كان يبدأ بالتبرز في الشارع أمام الملأ، وينتهي بإلقاء الجثث المتحللة من النوافذ في انتظار أن تمر عربات نقل الجثث وتدفنها في مقابر جماعية ضواحي المدن، واعترفت بها وثائق رسمية من إسبانيا بين 1561 و1761 كيف أن مدينة مدريد مثلا كانت تمتلئ بالقمامة، وفي إسبانيا، وبعد سقوط الأندلس وطرد المسلمين أو قتلهم، تحولت مدن البلاد التي كانت مثالا في النظافة والجمال إلى كرنفالات للزبالة، بينما منَ الله علينا بشريعة سمحة طيبة تنشر الطهارة والجمال، أقلها الوضوء للصلاة على طهارة خمس مرات في اليوم، لكنهم لا يأبهون إلى حساب الله الخالق ويتهجمون على نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين، ويُدنسون الأقصى والقرآن، ويتشدقون منذ أن خلقهم الله أشتاتاً يتيهون في الأرض بلا مأوى، بأرض الميعاد من النيل للفرات، ويقتلون أبرياءنا حتي الأطفال والنساء لم يسلموا منهم، ويريدون تهجيرهم من أرض ولدوا فيهم وهُم أحق بها.
لقد كانت علاقاتهم ليست ودية مع الماء (أصل الحياة، حتى صار الأوروبي وسخا إلى درجة مقززة، باستثناء حقب معينة من التاريخ الروماني، وباستثناء طبعا العادات الشرقية في الاستحمام، حيث انتشرت الحمامات والعطور بشكل كبير في الشرق والبلدان الإسلامية، بينما ظل الإنسان الأوروبي يعاني من خوف مرضي من الماء، فلم لا وهم من يمنعون الماء عن أبرياء غزة؟ ودعمهم لتاريخ من القذارة البشرية اليهودية التي تدعمها الماسونية العالمية، بآلات حربية وأسلحة دمار شاملة، وإعلام مضلل للحقائق، لا تري فيها إلا أنفسها، فقط لأنهم من وضعوا القواعد الدولية متحكمين في مصار العباد، وهم لا يعلمون أنهم أضعف من بيت العنكبوت، وسبحان الله من له الجنود الكثيرة وجعل أوروبا تحارب بشراً من الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين هنا وهناك، وقد سلط الله عليهم حشرة "البق"، في الأماكن العامة وخصوصًا مترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، لتعيش فرنسا ودول الاتحاد الأوربي أسوأ كوابيسها، وليس بجديد فهو مرض قديم أصاب فرنسا في الأربعينيات، وينبئ بأشياء تمس بالنظافة، فينتشر مرض الطاعون فيهم، حيث حصد نصفهم أو ثلثهم بين فترة وأخرى، حتى الهنود الحمر كانوا يضعون الورود في أنوفهم عند لقائهم بالغزاة الأوروبيين بسبب رائحتهم التى لا تطاق .
وبعد أن أهلكت أوربا الأوبئة التى كانت تحصدهم بالملايين بدأ الأوروبيون يكتشفون أن الماء لم يكن سيئا إلى تلك الدرجة، فكانت القذارة تتأقلمُ وتتحالف مع الحروب والمجاعات والأوبئة لكي تحصد ملايين الأرواح منهم، ليصدروها انتقاماً من العرب والمسلمين، وكانت هذه معضلة إنسانية استمرت قرونا طويلة نراها في منعهم الماء عن أهل غزة المُحاصرة منذ سنوات.
لقد أطعمناكم وأطعمنا العالم كلهُ وما زلتم تنعمون بخيرات حدائق العرب ومسلميه، ففي ذروة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009، تدخلت دول الخليج وأولهم السعودية والإمارات لدعم العديد من البنوك الغربية رغم تعرض اقتصاداتها في ذلك الوقت إلى تداعيات الأزمة مع ما شهدته أسواق النفط من تقلبات حادة في الأسعار. ورفعت حركة التحرّر العربية في الخمسينيات من القرن الماضي، شعار "بترول العرب للعرب". وأصبح شعاراً شعبياً من المحيط إلى الخليج، ولا سيما مع مجيء مرحلة أنور السادات في مصر، وتفاقم النزعة القـُطرية، فماذا لو رفع شعار "بترول العرب للعرب" مرة أخرى في حرب غزة القاتلة للأنفاس والمحاصرة من دول العالم القذر على مرأى ومسمع، مع اشتداد الهيمنة الأميركية والدعم الأوربي لبني صهيون، وكأن (معتصماه) قد مات من بيننا.. إنهم لا يأبهون طالما خزائنهم ممتلئة من أموالنا ولهم الحق يتلاعبون بها ويمنعونها عنا ويجمدونها في بنوكهم، ويُحاصروننا بها كحبل على الأعناق، بل ويستخدمونها في تمويل ألد أعداء الله في الأرض بني يهود وماسونيتهم القذرة، مُتكالبين على قطعة من أرواحنا أرض الأقصى، ونحن لا حول لنا ولا قوة، وحتى الآن ما زالت الأرقام الفلكية أودع -وما زال يودع- في الغرب، في البنوك والبورصات والعقارات وسندات الدول، لا يمكن أن تُسترجع، بدليل أن الحكومات التي خرجت بعد الثورات الشبابية الشعبية، وجدت طريقها بطلب القروض والاستثمار والسياحة من أميركا وأوروبا، فيما الأموال العربية النفطية -الفائضة عن الموازنات واستهلاك الداخل- لا تعرف لها طريقاً سوى الانتحار اللذيذ والإرادي في الغرب، وهي أموال لا يستطيع الغرب أن يعيد عُشـُر معشارها، لأن اقتصاده المأزوم يعتمد عليها ولا يحتمل إعادتها، فكيف يجوز أن نتعامل كالغرباء بالنسبة إلى حاجتنا؟ فهل نحنُ لا نستفيق إلا بعد فوات الأوان؟ وهل لنا كلمة في تلك الغزوة الهمجية على أبرياء فلسطين؟ إننا نحتاج إلى إعادة صوْغ العلاقات بيننا. فأواهُ يا عربُ.. أواهُ!
ليفانت - د. إبراهيم جلال فضلون
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!






















